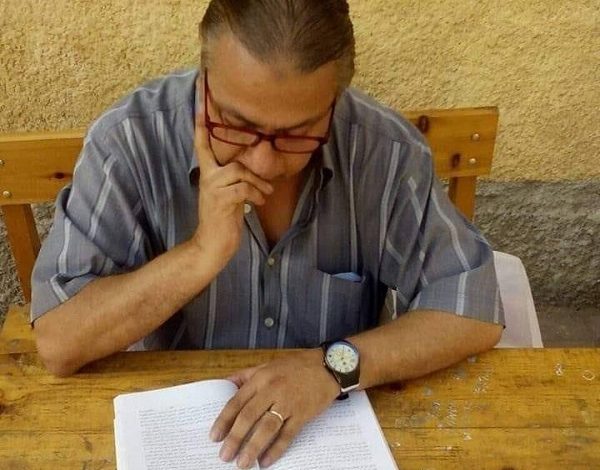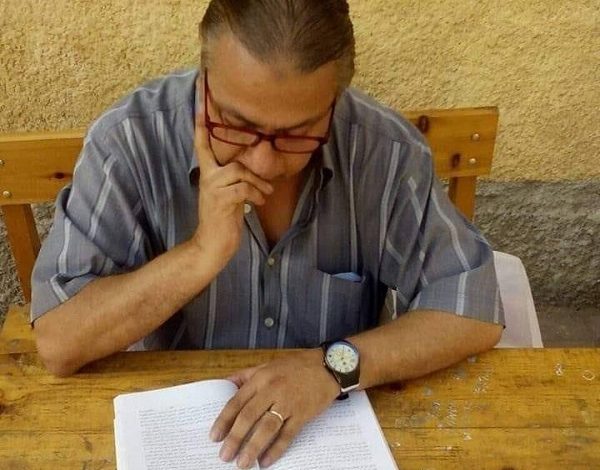لم يحظ مفكر في الدراسات الإسلامية من اتهامات وشكوك في مشروعه الفكري، مثلما حظي المفكر الجزائري (محمد أركون 1928: 2011)، فمنذ دراسته بفرنسا كباحث من 1960 إلى 1969 وهو في رعاية مستشرقين أمثال برونشفك وشارل بيلا وكلود كاهين، حتى حصوله على منصب أستاذ كرسي بالسوربون عام 1972م.
ويصف أحد الباحثين بأن تلك الفترة شهدت مخاضا كبيرا وتحولا عميقا في جميع الأبنية السياسية والاجتهادية والذهنية في فرنسا والغرب.. ويقول إدريس هاني إن مشروع أركون بخصوص علاقته بالتراث أنه يمثل القطيعة الوسطى بين قطيعتين هما الكبرى والتي تتجلى في إنكار الصلة بين الحاضر والماضي والقطيعة الصغرى التي تعترف بصلة حتمية بينهما لا اختيار فيها.
أما قطيعة «أركون» الوسطى تتجاوز القطيعتين السابقتين عند الاقتضاء، وهو مشروع لا مأوى له على سبيل التموضع إلا في هذه المنطقة الوسطى، إلا أن هذا التموضع الوسطى لايفهم منه الحيز، بل لابد أن ننظر إليه كحالة يتجادل فيها ما هو تجلى للقطيعة الكبرى مع ما هو تجلى للقطيعة الصغري كما يقر بأن أركون يرى أن التراث يستمر فينا بشكل من الأشكال ومن ناحية أخرى فإن أركون يشمئز من الايديولوجيا ويعتبرها مفسدة للبحث العلمي.
ويقول أحمد كنعان (من رابطة العلماء السوريين) إن هاشم صالح تلميذ أركون والمترجم لبعض أعماله إلى العربية يصف أستاذه بقوله (إن أركون كاتب متناقض حيران لايؤمن بشئ وانه يعظم الفكر الغربي العلماني ويجد عنده الحقيقة وانه لايري للعلوم الإسلامية والتراث الإسلامي أية مكانة إلا ماله تقدير في عين المدارس النقدية الغربية، وانه يرى أن المعرفة الإسلامية نموذج أسطوري يجب أن يخضع للدراسة والتغيير كما يرى أن القرآن نص أسطوري قابل للدراسة والأخذ والرد: محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمية ص 22 وما بعدها.
وعن علاقة «أركون» بالتراث فإن المفكر العراقي وسام صبيح يقرر أن أركون يرى أن هنالك مهمتين تفرضان نفسيهما في آن واحد إلا وهي تحديد معنى التراث والحداثة إذ يشير أركون إلى عدم إمكانية روابط حية مع التراث ما لم نضطلع بمسؤولية الحداثة كاملة وبالمقابل فإنه لا يمكن لنا المساهمة في إنجاز الحداثة بشكل ابتكاري إذا ما استمرينا في الخلط بين التراث التاريخي والتراث (الميثولوجي) الأسطوري، ويقرر المفكر الموريتاني الدكتور السيد ولد أباه ان أركون يصنف أعماله دون تمييز في إطارين نظريين هما (الإسلاميات المطبقة) و(نقد العقل الإسلامي) وتحيل العبارتان إلى سياقين منهجيين متباينين فالإسلاميات المطبقة مستمدة من مفهوم (العقلانية المطبقة) الذي بلوره مؤرخ العلم الفرنسي غاستون باشلار.
أما مقولة نقد العقل الإسلامي فتحيل إلى كتاب إيمانويل كانط (نقد العقل الخالص) وتحمل العبارة الأولى طموح أركون لتطبيق مناهج العلوم الإنسانية المعاصرة على النص الإسلامي وتحمل العبارة الثانية طموحا أوسع بتمديد تركة الإصلاح الديني والتأويلية النقدية إلى التقليد الإسلامي على غرار ما حدث في التقليد اليهودي والمسيحي، وصولا إلى غاية (علمنة المجتمع الإسلامي وتنويره).
والإسلامية المطبقة يعرفها «أركون» بأنها تدرس الإسلام ضمن منظور المساهمة في العامة لإنجاز الأنثروبولوجيا الدينية، ومن هنا يقول ولد أباه إن النتيجة المنهجية التي حاول أركون تطبيقها على النص القرآني وهي منهجية كانت قد طبقت على النصوص المسيحية وتتلخص في إخضاع القرآن الكريم لمحك النقد التاريخي المقارن والتحليل الألسني التفكيكي والتأمل الفلسفي المتعلق بإنتاج المعنى وتوسعاته وتحولاته وانهدامه.
وعن موقف «أركون» من الموقف الأصولي التجديدي عند الإمام الشاطبي فيقرر الدكتور عبد المجيد الصغير بأنه موقف غريب إذ لا يفهم عند أركون بإرجاعه إلى بيئته الفكرية أو التاريخية بقدر ما يفهم بإدراجه ضمن طريقة (المدراش اليهودي) الضاربة في أعماق تاريخ بني إسرائيل أو بإرجاعه مع غيره من المواقف الأصولية والكلامية إلى (القاموس الصغير للثيولوجيا الكاثوليكية) الذي يصير له عند أركون (مرجعية) غير قابلة للنقاش في ضوئها يحاول أن يفهم الفكر الأصولي والكلامي بدلا من أن يفهمه في حدود ملابساته التاريخية الفعلية.
كما أنه أصبح ملاحظا عند أركون إسقاط الصور التاريخية بعضها فوق بعض، فأصبح الحديث جائزا والخلط ممكنا بين (فقهاء الإسلام) و(النظام الإكليرجي) لدى أساقفة المسيحية، وحاخامات اليهود وهذه مقارنات إسقاطية لا تاريخية وان أركون يطلق أحكاما مرسلة غير مبرهن عليها كقوله: إن الصيغ الإسلامية المشهورة من قبيل ( الله اكبر) و(لا إله إلا الله) تعني في آخر المطاف إلغاء العقل البشري وطرده من التاريخ.