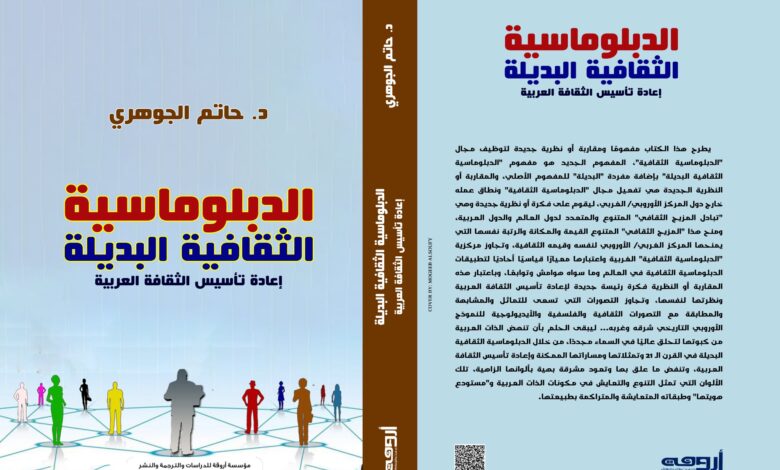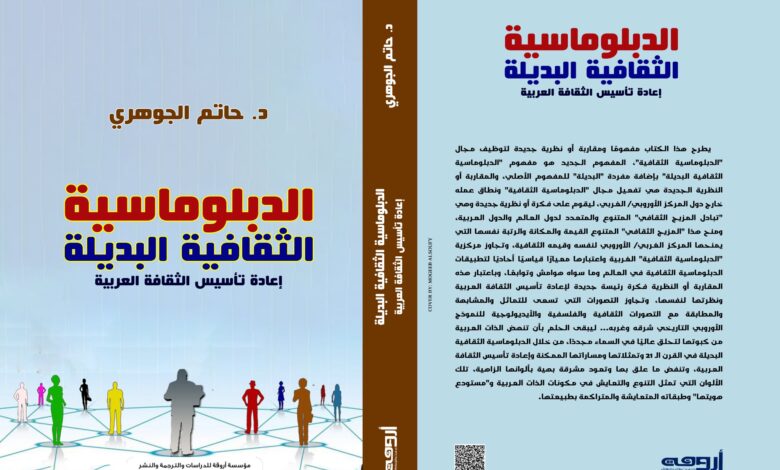بقلم الدكتور حيدر الجبوري .. وزير مفوض بجامعة الدول العربية

نحن أمام وثيقة مهمة أصدرتها “مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشر” بالقاهرة؛ بعنوان: ” الدبلوماسية الثقافية البديلة.. إعادة تأسيس الثقافة العربية”، لمؤلفه الدكتور حاتم الجوهري، وهي ثمرة نتاج المؤلف ضمن سياق قراءة عربية معمقة للدبلوماسية الثقافية البديلة نحو إعادة تأسيس الثقافة العربية.. هذه الوثيقة (الكتاب) الذي يتضمن في فصوله الستة مجموعة مقالات نشرها المؤلف في صحف ومواقع شتى، إضافة الى مجموعة من الحوارات الصحفية التي تندرج في السياق ذاته، والتي جمعها الكاتب في هذا الكتاب (الذي يتكون من 320 صفحة) هو ثمرة جهد دؤوب امتد لسنوات يحسب للمؤلف أنه جمعه بكتاب شامل له.
بداية؛ يمكن القول أن الكتاب يقدم لنا سردية نظرية لمفهوم الدبلوماسية الثقافية العربية لتكون حاضرة بقوة فاعلة من خلال (دبلوماسية تبادل المزيج الثقافي) التي ميزها الكاتب عن مفهوم السياسة الثقافية التقليدية أو النمطية للدولة على المستوى الخارجي، من خلال تصور البلدان لكيفية تقديم مزيجها الحضاري والثقافي للآخرين، حيث اعتبرت العديد من الدول الغربية مفهوم الدبلوماسية الثقافية احدى وسائل فرض هيمنتها ونفوذها عبر قواها الناعمة عن طريق مراكزها الثقافية وبرامجها التي تنتشر في دول العالم الأقل تطورا.
وهنا يطرح المؤلف أهمية ابراز مشروع حضاري جديد تكون له تمثلات معبرة عنه تجعله مؤثراً بما يؤهله لكسب الاحترام على المستوى الدولي، حيث يختار الكاتب مصر المؤهلة لتبني هذه الدبلومسية في ظل التدافع الحضاري الحالي مع الغرب، ذلك أن مصر تمتلك المشتركات الثقافية على المستوى الاقليمي، فضلاً عن امتلاكها “المتقابلات الثقافية” المتنوعة والمتعددة على المستوى العالمي.
ثم يعرج الكاتب بمقالته التي نشرها «الحوار المتمدن»، في العراق في أغسطس 2024 على موضوع الوعي الجيوثقافي ودور الدبلوماسية العامة، حيث يرى أن هذا المفهوم يصعد سريعاً بوصفه محركاً للسياسات العالمية واستراتيجياتها الكبرى في القرن الحادي والعشرين.
ومن هنا تتأتى الأهمية القصوى للدبلوماسية العامة التي تمارسها الدول لتحيط بهذا المفهوم ودوره وأهميته، حيث أن الدبلوماسية الثقافية يمكن أن تكون جسراً موصلاً بين الجانب الجيوثقافي والدبلوماسية العامة والسياسات الخارجية للدول العربية.
وما بين حواري الكاتب المعنونين (المشترك الثقافي العربي، والدبلوماسية الثقافية المصرية في القرن الحادي والعشرين) و(طريق الحرير الجديد: الاتجاه شرقاً لكسر هيمنة الغرب ثقافيا)؛ يبحث كاتبنا عن استقطابات حضارية تمتلك مساحات واسعة من المشترك الثقافي الطبيعي بحاجة الى استثمار فقط، لأن عوامل عمقها حاضرة، ومؤهلة في مجابهة استقطابات الحضارة الغربية، فإذا ما تمكنا من تجاوز بعض التناقضات الطارئة ودعم المتن الحضاري الثقافي العربي واستشراف بدائله للمستقبل تمكنا من تجاوز سردية الهزيمة وسلبيات الارتهان للثقافة الغربية. وهنا تنبري «حاجة تبني العرب لسردية كبرى»، التي يطرحها الكاتب في مقالته بجريدة العرب اللندنية في نوفمبر 2018 وهي سردية جديدة تواجه العالم وتبحث من خلالها عن ذاتها عبر تحقيق اشتراطات تجاوز السلبي من القوالب التقليدية التي تبنتها الشعارات السائدة منذ القرن الماضي، وبقاياها التي أتقنت العويل والبكاء على الحال، وهنا تنهض فكرة البحث عن نقطة ارتكاز أو لحظة مفصلية نبني عليها سرديتنا الجديدة، لحظة تنفض غبار ما تراكم على ثقافتنا، للانطلاق نحو آفاق جديدة.. ذلك الفصل الأول.
في الفصل الثاني المعنون “مبادرات وتطبيقات في الدبلوماسية الثقافية البديلة” يحاول الباحث أن يلفت انتباهنا نحو بعض الآليات في سبيل تحقيق هذه الغاية، مثل منتدى التبادل الدولي ودوره في حماية التراث الثقافي غير المادي حيث يؤكد الكاتب في كلمته التي القاها في العاشر من سبتمبر 2017 نيابة عن وفد وزارة الثقافة المصرية في سيمنار علمي شاركت فيه وزارة الثقافة الصينية ممثلة بـ”الأكاديمية المركزية للإدارة الثقافية” للتعرف على التجربة الصينية في مقاربة التراث الثقافي غير المادي الصيني وسبل الحفاظ عليه واستدامته وذلك من خلال اشارته الى أهمية هذا المنتدى للتبادل والتواصل الحضاري عبر التقاء العديد من الثقافات المتنوعة التي تضيف للجميع، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات في مجال دمج واعادة تضفير عناصر التراث الثقافي غير المادي داخل الحياة اليومية مجدداً للمواطن العادي.
كما يطرح الكاتب نموذج مبادرة “رأس الرجاء الصالح”، لاعادة الروح للثقافة عبر مد جسورٍ من الصداقة مع شرق آسيا ثقافياً، وكذا “طريق الحرير” وخاصة أن الصين توصلت الى معادلة جديدة تجاوزت فيها مفهوم الفكر الشمولي الذي يقهر التنوع الثقافي بحجة التنميط وخلق المجتمع المادي الذي يتحرك كالآلة دون تمايز ثقافي أو فكري أو روحي، إذ تمكنت الصين عبر التحول نحو الاقتصاد الرأسمالي تجسير الهوة الاقتصادية مع الدول الغربية باستثناء ما يميزها ثقافياً وتاريخياً فاستطاعت خلق واستقطاب طبقة من النخب عبر مختلف القوميات والعرقيات الصينية.. ومن هنا تحظى المبادرات الثقافية الجديدة باهتمام الكاتب التي يختار منها نموذج الملتقى الثقافي الصيني المصري، واختيار منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة القاهرة عاصمة للثقافة الاسلامية عام 2020، ثم “المركز العلمي للترجمة” باعتباره أداة لدبلوماسية تغيير الصورة النمطية إذ يسرد المؤلف تجربته في إدارة المركز الدولي للكتاب بالهيئة المصرية للكتاب حيث وفق بوضع بروتوكول حاكم له وتمكن في فترة قصيرة من تحقيق أرقام مبيعات قياسية وبمجموعة من الندوات المتنوعة صارت للمكان روحاً مميزة أهلته لأن يحصل على جائزة الدولة لترجمته «تأملات في المسألة اليهودية»، لجان بول سارتر وغيرها.. حيث أن وضع الترجمة بما يواكب الاحتياج الحضاري الجديد لبلادنا في ظل استشرافها لمستقبلها يتطلب معرفة ثقافات وعلوم الاخرين ومواكبتها.
وحينما ننتقل الى الفصل الثالث، التراث الثقافي ودوره في الدبلوماسية الثقافية البديلة، نرى ان الجوهري يعرج على دور الهوية والتراث الثقافي في الدبلوماسية الثقافية، متخذا من اتفاقية اليونسكو لعام 2003 لحفظ التراث الثقافي غير المادي (وهو المصطلح الجديد الذي تبنته اليونسكو للموروث الشعبي) التي سنحت الفرصة للكاتب أن يشارك في ورشتها الاقليمية لتعزيز التعاون العربي لتفعيل بروتوكولات هذه الاتفاقية التي عقدت في القاهرة، وهي أقرب لفكرة السياسة الثقافية العامة منها لمجال المتخصصين في الموروث الشعبي، إذ يعد الكاتب ان لب الاتفاقية الامساك بالذات وتراثها الثقافي وقوتها الناعمة معتبراً أن أنجح التجارب العالمية في هذا الصدد هي تجربة الصين، ذلك أن المفهوم تواكب مع مشروع الصين الحضاري لتقديم نموذج ثقافي مغاير للغرب، وهو ما يدعو مصر والعرب للأخذ به، معززاً هذا الطرح بمقاربة لاحقة للتدافع الحضاري غير المادي حيث يقول: (يمكن للثقافة أن تسير في طريقين متوازيين في الدورة الحضارية العامة، الأول يكمن في العمل الايجابي والمبادرة والبحث عن سيناريوهات المستقبل والعمل كرافعة تستكشف طريق المجتمع وتختبر احتمالاته وفرص نهضته واستعادته لذاته المتفوقة. والثاني يكمن في فكرة التأمين أو الدفاع وتحصين الذات في ظل فترات الضعف وغياب النموذج الحضاري القوي المعبر عن الأمة، عبر حفظ ذاكرة الأمة وعاداتها وتقاليدها ومروياتها.. وهو ما أصبح ينتظم حديثاً ويدرج تحت مفهوم “التراث اللامادي الثقافي”).
بل أبعد من ذلك، يرى الكاتب ضرورة إعادة توظيف التراث والسياسات الثقافية في هذا الاتجاه، حينما يوضح أن ذاكرة الأمة هي “مستودع هويتها” وهي ما تميز كل جماعة بشرية عن الأخرى، وبهذا فهي الحاضنة القوية أمام تقلبات التاريخ، ومن هنا تأتي أهمية إحياء التراث (مع تركيز الكاتب على دور احياء التراث في الحفاظ على تعزيز الحضارة والهوية المصرية) حيث يؤكد أن الهوية المصرية ليست مجرد تراث شعبي يعبر عن اعتزاز بالقومية أو الذاكرة الجمعية فقط، فهي حزمة ومخزون حضاري رافع لوجود الدولة في لحظة تاريخية محلية واقليمية ودولية شديدة التدافع. وبناء عليه يعطف الكاتب مقالته اللاحقة الأكثر شمولية، بالتأكيد على سياسة ثقافية جديدة لاعادة توظيف الموروث العربي، وصولاً لمشروع للتعاون الاقليمي العربي من خلال تبني قائمة استرشادية عربية مشتركة للتراث الثقافي غير المادي بدلاً من تركيز دولنا العربية على التقدم بعناصر مستقلة غير جامعة للأمة.
أما الفصل الرابع من الكتاب، الذي خصص لدبلوماسية المشترك الثقافي العربي أنموذجا بديلا، غاص الدكتور حاتم فيه بفلسفة المشترك الثقافي العربي طامحاً للوصول الى مدرسة لدراسات ثقافية عربية مقارنة، لا سيما أننا نعيش لحظة حضارية فاصلة تتسم بتحديات وجودية خارجية وداخلية ملحة تواجه معظم دولنا العربية، كل ذلك مع افتقاد العديد من المؤسسات الثقافية العربية للكوادر الحاضرة التي تملك القدرة على التعامل الفعال مع العديد من ملفات الثقافة الخارجية أو الداخلية وربطها بالسياق العام لدولنا ومجتمعاتنا، حيث تربط بين الأمل والحلم ومستودع الهوية العربي، وبين القدرات المحدودة لبعض دولنا وهي تواجه تحديات مصيرية خطيرة، ما يحتم علينا تجاوز تناقضات الماضي وإرثها مع تجاوز فخ “المسألة الأوربية” ومتلازماتها الثقافية المغلفة بالاختيار المادي المتطرف والعقلانية المجردة المتشددة الخيالية والمثالية، التي أهملت التمايز الثقافي التاريخي في العموم وطبائع النفس البشرية المتفاوتة في استقبال الظروف المختلفة.
وما بين تناول الكاتب للدراسات الثقافية العربية المقارنة، التي أبرز الكاتب منها بيان الرؤية والطموح الذي تبناه المشترك الثقافي بين مصر وتونس الذي عقد في القاهرة عام 2022، وصولاً الى تطبيق الدرس الثقافي الحر القيمي على واقع الذات العربية وفق منهج علمي حر غير مقيد بالانتصار للهوامش وعقدتها، يبحث عن القيم الانسانية العليا، تمكن الكاتب أن ينسج لنا نسقاً قيمياً يتجاوز غواية تبرير الهامش وتسويغ انحرافه بحجة الظروف وتقديمه دور الضحية، حيث أنه يصر على تبني منهج يبحث عن جدل الذات العربية مع نفسها وفق سياق أوسع لما يمكن تسميته بدراسات ما بعد الاستقلال التي تختلف عن دراسات ما بعد الاستعمار، لتتجلى الذات العربية المختارة باعتبارها كياناً كلياً جامعاً وليست بنية أحادية، فهي ليست مجرد صفة قومية أو عرقية، فهي ذاتٌ ترتبط باجتماع مجموعة خصال وسمات تشكل طبيعتها، وهي مختارة لأن الانتماء لها يقوده فعل عقلاني يقوم على الارادة والاختيار من بين متنوع ومتجاور ومتراكم ضمن مستودع هوية زاخر بطبقات تاريخية حملت الموجات الاولى من الحضارات البشرية للعالم. مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هناك آفاق دبلوماسية وأكاديمية مستقبلية كثيرة مفتوحة أمام مجال الدراسات الثقافية العربية المقارنة، كما يرى الكاتب، ترتبط بدراسة الظواهر الثقافية والانسانية، وهي إجمالاً دراسة ثقافية تبحث عن أنساقها الكامنة ومسبباتها العميقة في مستودع الهوية الانسانية الجامعة وفقاً لمتن عربي جديد ومشروع ثقافي جامع عبر استعادة القيم الكبرى من الآيديولوجيات المضادة لتجاوز المتلازمات الثقافية الغربية.
وكل هذا يقودنا للولوج الى مشروع الكتاب الاساس أو بيت القصيد كما يقال، وهو الهدف الاسمى الذي يتجسد في اعادة تأسيس الثقافة العربية وآفاقها البديلة (موضوع الفصل الخامس)، وبدائل الثقافة العربية بين الذات والآخر والأدب والسياسة (موضوع الفصل السادس). حيث يبدأ كاتبنا بمناقشة مأزق الثقافة العربية في حواره لصالح مجلة “حروف الضاد” الفلسطينية في شتاء 2023 حيث يؤكد الجوهري أن البلدان العربية بحاجة لدور مثقفين فاعلين جدد يعيدون بناء الثقافة العربية بعيداً عن الاصطفاف في اليمين أو اليسار، مثقف يتعامل مع الظاهرة البشرية بأفق منفتح، يرصد الظواهر الحالية ويفترض الحلول ويختبر صلاحياتها بما يمكن الثقافة العربية من تجاوز أزمتها الناجمة من إرث القرن العشرين.
========
نقلا عن مجلة آفاق التجديد