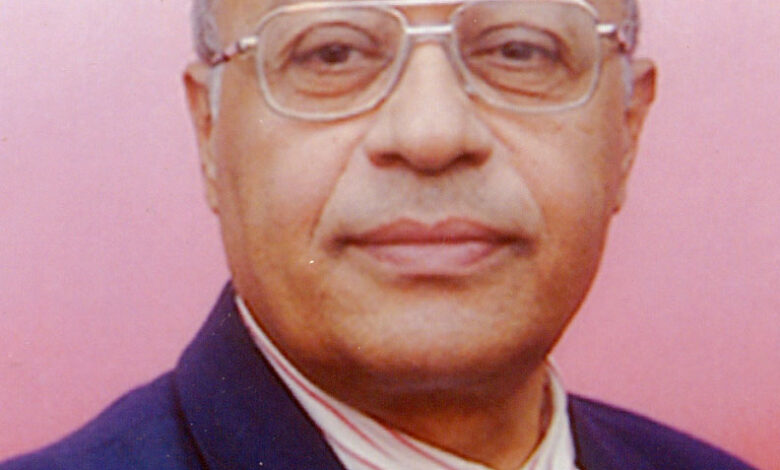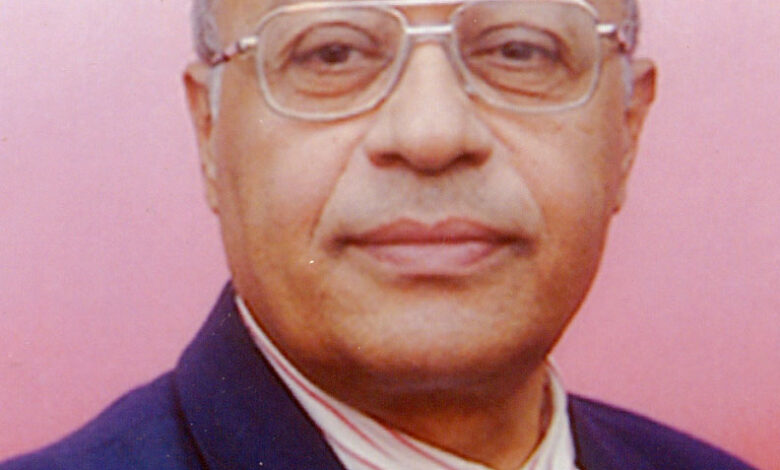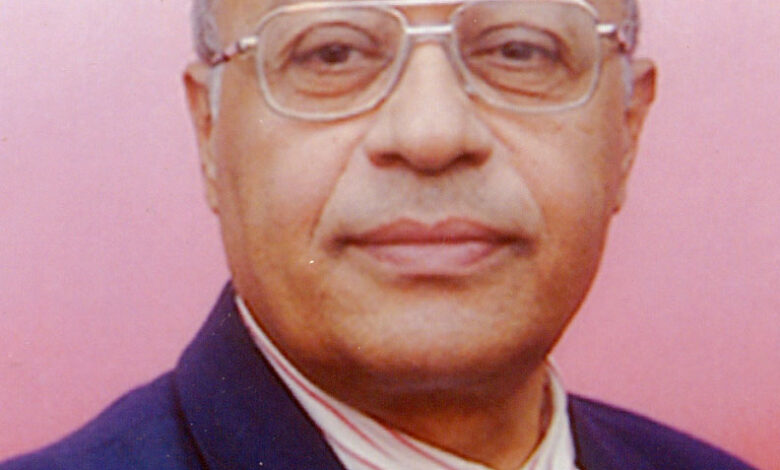ماذا عن ترسيخ الهوية فى الآداب النسوية؟ قبل الإجابة على السؤال، ثمة التباس في المصطلح.. البعض يحدد الفارق بين مصطلحى (النسوية) و(النسائية)، بمعنى أن مصطلح (النسوية) يعنى ما يتعلق بقضايا المرأة فى الثقافة، سواء أكتبه الرجال أم النساء.. أما مصطلح (النسائية) فيعني ما تكتبه المرأة بنفسها وبقلمها تحديدا.
وأرى أن ثمة خلطا بين المصطلحين .. إنها محاولة تشريحية مفتعلة تماما، لأن الأدب يهتم بكل ما هو إنسانى، والمرأة إنسان، مثلها مثل الرجل في الحس والشعور والاهتمام بقضايا التحرر، وهي عمود الأسرة.
وقديما كان الرجل ينسب لأمه .. ولا زالت بعض القبائل تفعل ذلك، بل ينسب المرء (ذكرا وأنثى) لأمه.. وكما يفعل اليهود، وكما يصنعون في عالم السحر .. اسم الشخص ثم أمه، وأثر به عرقه، ثم يصنع (العمل) .. وإن سألت لماذا؟ كانت الإجابة أن الأم هي الأصل .. والأب مجرد عابر!! لا أريد أن أكون ملكيا أكثر من الملك.
ولنأخذ القضايا، فى قصة (كانت هى الأضعف)، وهى قصة قصيرة ضمن مجموعة (الخيط والجدار) للدكتورة نوال السعداوي، نجد شابا سقط ضحية أمه المتسلطة الصلدة الجسد، فسلبت ابنها الشاب القدرة على الحياة وأورثته عجزا جنسيا يضنيه، فهو غير قادر على أن يدخل بعروسه، وإن جاءوا بها ذبيحة بين يديه.. ثمة جدار ضاغط فى شكل جنسي، يتكرر هذا في المجموعة كلها.
على أية حال، ألم يخصص الأستاذ نجيب محفوظ رواية ضخمة لتجسيد هذا الموضوع؟ فى روايته الضخمة (السراب) كان البطل ضحية لرعاية أمه المبالغ فيها وحمايته من شر الحريم، حين منعته من تجربة ناقصة مع خادمة أنثى – إمرأة أكبر منه – بل في عمرها. وحوطت عليه من كافة العلاقات والأصدقاء، فكان كما يقال (ابن أمه)، وجسدتها الشاشة المصرية وقام بدور الشاب (نور الشريف)، فلماذا يجري الكلام عن (الأدب النسائي) وكأننا نتكلم عن (أدب آخر) و (جنس آخر).
بدهى، أن المرأة الشاعرة/الروائية/الكاتبة، تنتمى بحكم جنسها إلى (المرأة) كنوع، وأن نجد (نبرة أنثوية) في نسيج وأعماق العمل الأدبى.. ومن الطبيعي إذا وجدت القهر والظلم يحلقان بالمرأة كإنسان في المجتمع، فإنها تتصدى لهذا القمع والظلم وترفع خطابها الأدبى فى شكل يدين هذا الاختلال، بمعنى أنها تنحاز للمرأة الإنسان.
ولعل المشكلة تكمن في الجدار العازل الذى يفصل الأنثى عن الذكر، ونقصد به الأيديولوجيا الذكورية القائمة.. وكلما اشتد الجدار العازل، وكلما كان هناك تميز عنصري، فإن (الأنثوية) تنهض كحالة مبررة فعلا.
والعجيب أنه قد مضى أكثر من مائة عام على كتاب (تحرير المرأة) لقاسم أمين. وهو كاتب رجل .. لكنه عاش فى زمن الحرملك والبرقع والتمييز ضد المرأة.. إنه رجل يحب أمه وخالته وعمته وأخته ونصف البشر .. بل كل البشر، فكان منصفا لحرية المرأة.. إنها المناصرة الصريحة للمرأة من الانتلجنسيا المصرية/العربية المستنيرة.
مائة عام مضت على قضية تشعر المرأة أن ثمة تراجعا كبيرا، وأن ثمة هجمة شرسة، خطاب ديني متطرف ومعارك غريبة حول الحجاب ووضع الحواجز والمدافع أمام حرية التفكير والتعبير.
أليس عجيبا أن يحدث هذا بعد مائة عام، لكن ثمة تراجعا في المد الثوري العربي وفى الفكر القومي.. انطفأ مشروع الوحدة، بل انطفأ الحلم الاشتراكي، وظهر التفتيت في كيانات البلدان العربية، وجاءت «العولمة» .. وكنا غرباء، وظهرت القيم الاستهلاكية المدمرة التى قسمت ظهر أمريكا والغرب، واحتاجت لتدخل الدولة!
أما نحن فحدث ولا حرج عن استهلاك المكيفات والمخدرات والهواتف المحمولة، ومجتمعاتنا تتوارث الصراعات القبلية والطائفية (فى العراق سُنة، وشيعة، وأكراد)، وفي لبنان كل ألوان الطيف الطائفية، وفي مصر أقدم دولة مركزية فى العالم، ظهرت أحياناً الطائفية البغيضة (مسلمين ومسيحيين)، مع تجاهل ما رفعته الثورة الكبرى (ثورة 1919) وعناق الهلال مع الصليب!
في وسط هذا المناخ الصاخب والغاضب، مازال البعض – بل وجد البعض – مبررا لمجرد طرح الجانب الآخر الأنسوي والنسوي.. وأعتقد أن الحاجة ماسة للتعامل مع النصوص نفسها وتحليل مضمونها والاهتمام بالإبداع كمنتج إنسانى يطارح حياة الإنسان العربى، وهو يصارع قوى التخلف من ناحية، والتزام الكتابة بالهم الإنسانى، وهذا موجود فعلا.
أطلب أن نقرأ الأدب باعتباره فنا، بغض النظر عن كاتبه، والفن لا نختلف في تحديد طبيعته، وإن اختلفت الآراء في تقييمه.. والاختلاف لا ينبغى أن يفسد للود قضية، وهو عند البعض- يقينا- يفسد مليون قضية !!