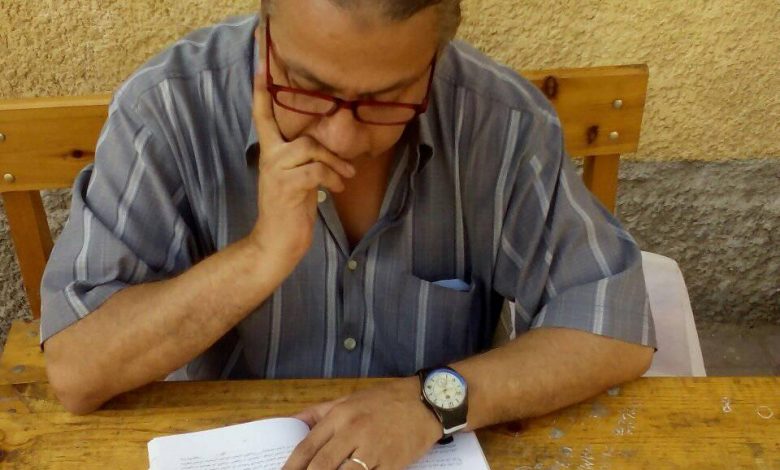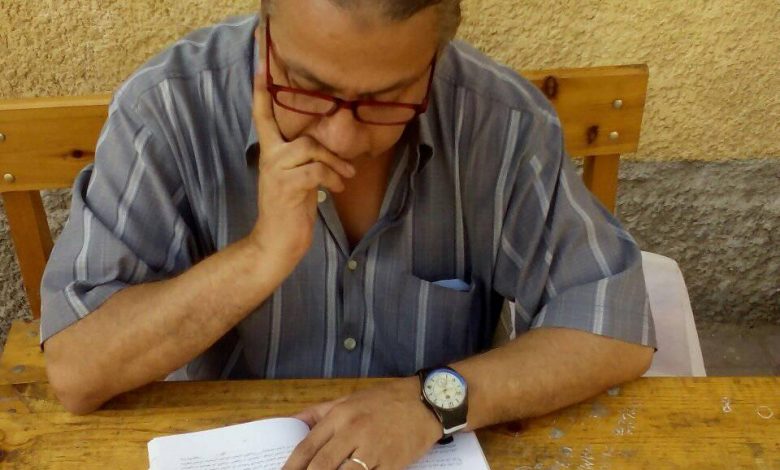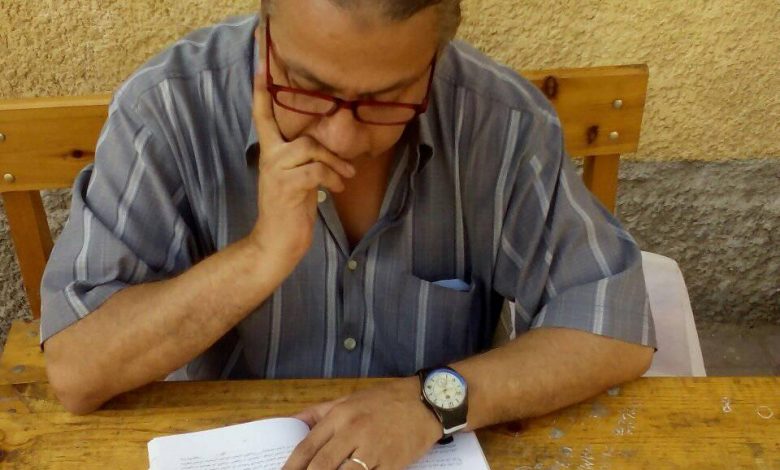كشف ما وصف بطوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023م، عن عدد من القضايا ذات الأهمية القصوي، تتمحور حول؛ أولا: توصيف المقاومة في فلسطين المحتلة، وثانيا: تفتت المقاومة، وثالثا: ضمير المقاومة، ورابعا: أيادي الشياطين ومؤامراتهم الخفية، وخامسا: تحولات الغرب.
فقد حان الوقت لأن تراجع فرق المقاومة وفي صدارتها «حماس» وصفها ب«الإسلامية»، لأن ذلك له مردوده السلبي على قطاع غير قليل من الفلسطينيين المسيحيين، ففي ذلك جرح لشعورهم وانتمائهم الوطني، وإخراجهم من شرف المقاومة التي ينبغي لها أن توصف بالوطنية، فليس مسيحيو فلسطين بأقل وطنية من مسلميها.
ولا شك أن في تهميشهم وتجنيبهم بعيدا عن عملية المقاومة الوطنية، نوعا من الانتقاص من قدرهم، وربما فيه لون من التفريق الممقوت بين أبناء الوطن الواحد على أساس ديني ينفر منه الحس الوطني، ويأباه الإسلام، ويختصر من رصيد المقاومة في نفوس مسيحي الوطن.
ويعد ذلك سوأة من سوءات أي مقاومة في أي صقع على كوكب الأرض، إذا ما همشت قطاعا عريضا من أبناء شعبها.. وبدهيا فإن رصاص المحتل لا يفرق ولا يميز بين ضحاياه فهو يحصد الجميع.
وللمقاومة في مصر ضد الاحتلال بكل صنوفه أسوة حسنة، ومثل أعلى يحتذى به؛ فانظر إلى توحدهم «مسلمين ومسيحيين»، تحت مسمى المقاومة الوطنية ضد الفرنسيين والإنجليز والكيان الصهيوني أخيراً في حرب 6 من أكتوبر 1973م.
إن النصر في الوحدة لا الفرقة، ومن ثم يجب أن تكون مقاومة وطنية بامتياز ، كما أن تعدد وتفتت المقاومة الوطنية في فصائل وجماعات عدة ومن منطلقات متباينة في الرؤية والتكتيك بل والإستراتيجية.. أمر بالغ الخطورة على مستقبل القضية الفلسطينية.
إن هذا «التفتت»، يصب في مصلحة العدو الصهيوني، ومصلحة أي قوة إقليمية أو دولية متآمرة، مستفيدة من استمرار أمد الصراع، على أي نحو من الأنحاء، بالنظر إلى تحقيق أهداف أنوية ضيقة ومريبة، وهي بذلك لن تكف عن استقطاب بعض عناصر المقاومة الوطنية وإغوائها _ بغرور _ لتحقيق أهدافها الرخيصة، وتلك آفة متى أصابت المقاومة فلا تنتظر انتصارا مرجوا، ولا مكاسب وطنية محققة، ولا أرضا محررة.
على قوى المقاومة الوطنية الفلسطينية أن تنتبه لهذا «الإيدز الحركي»، الذي يصيبها بالضعف والوهن، وفقدان البوصلة نحو الهدف الصحيح، كما ينبغي أن يستيقظ الضمير الوطني لهذه المقاومة بإعلاء مصلحة فلسطين فوق كل اعتبار، وذلك بالتخلي عن رغبات السلطة، وأوهام الزعامة، وأن تنظر إلى القضية الوطنية نظرة عقلية رشيدة، لا طائشة ومتهورة، مدفوعة بأيدي الغير لا بيدها.
ولعل في السعي نحو المسار السياسي مهما طال أمده وصعوبته الحل الأفضل، وذلك بتغيير استراتيجيات السعي، ولاسيما بعد ما خلق طوفان الأقصى نوعا من الوعي الإيجابي لدى الشعوب الغربية والأمريكية بحقائق الصراع، وتعرية الادعاءات الصهيونية، بدلا من انتفاضة أو طوفان بين وقت وآخر لا يخلف إلا مزيدا من التدمير والقتل واسع المدى.
إن الحرب ليست نزهة، ولكنها كما قال شاعرنا العربي زهير بن أبي أبي سلمى: (وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم ** وماهو عنها بالحديث المرجم ).. وقال أمير المؤمنين عن الحرب بين المسلمين والفرس (أتمنى لو كان بيني وبينهم جبل من نار فلا يصلون إلينا ولا نصل إليهم ).
وبالطبع لا أقصد شل يد المقاومة، ولكن توحدها وترشيدها، وإحداث تغيرات جوهرية في استراتيجيتها، بحيث تكون قادرة على أن تكون قوتها متكافئة مع الجانب الصهيوني، لكي تحمي شعبها المسلوب من الآلة العسكرية الصهيونية، ومعاونيها العتاة الذين يبصمون بالتصديق على أي رواية صهيونية- كما شاهدنا في طوفان الاقصى.
وعلى المقاومة أن تضع في الحسبان حالة العجز العربي التام، والذي اختصر مهمته في مؤتمرات المناشدات والشجب والاستنكار، وقدر من المعونات اللوجستية، في الوقت الذي تحول فيه الخطاب الغربي في مجموعه إلى خطاب تأييدي أعمى وأصم للكيان الصهيوني دون أي قدر من التحفظ.
والأمر الأخير والأشد خطرا هو اعتماد فصائل المقاومة على دعم قوى إقليمية تلعب في الخفاء لمصالحها الخاصة وأهدافها التآمرية البعيدة، لمحاصرة الدولة المصرية، التي هي الحصن والملاذ الأول والأخير في مواجهة المشروع الصهيوني.
وبرأيي إن القوى الغربية والأمريكية والكيان الصهيوني، قد (تناومت ) إزاء طوفان الاقصى لتجدد مشروعها الصهيوني، وتحكم دائرة الحصار على مصر، بإلهائها عن الحرب الأهلية السودانية، والتهديدات الحدودية على الحدود الليبية، ومحاولة عرقلة مشروعات مصر التنموية، وإجبار مصر على تصفية القضية الفلسطينية بالضغط عليها لتهجير أهل غزة إلى سيناء.
ولا اظن أن الولايات المتحدة الامريكية ومعها الغرب الأوروبي ببعيدين عن صناعة هذه الحبكة الاستعمارية المتآمرة، في هذا المسلسل التراجيدي، الذي تتغير عناوينه وسيناريوهاته، وفق أجواء العرض !!